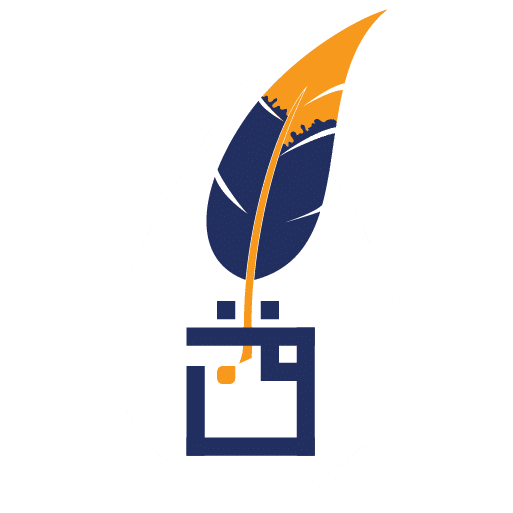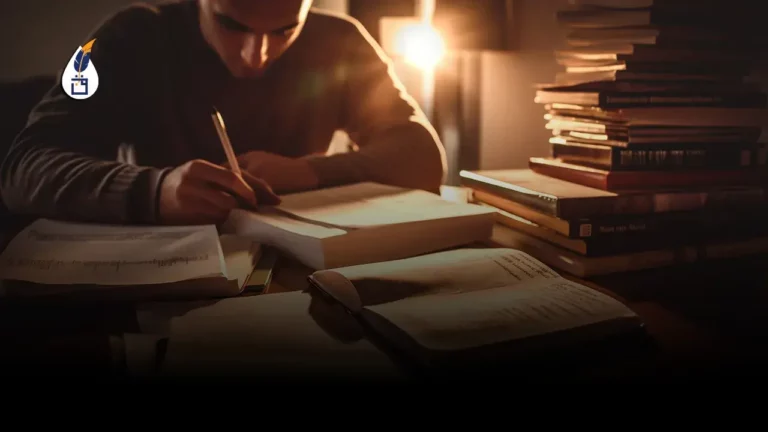من يدفع للزمَّار “جائزة نوبل”؟
م. ايمن قاسم الرفاعي

“إنني أغفر لنوبل أنه اخترع الديناميت لكنني لا أغفر له أنه اخترع جائزة نوبل؟” بهذا القول الجريء رفض الأديب الأيرلندي الشهير (جورج برنارد شو) جائزة نوبل للآداب حين تم الإعلان عن فوزه بها عام 1926م، ومنذ إطلاق هذذذه الجائزة عام 1901م وهي حديث الشارع العالمي العلمي منه والثقافي وحتى السياسي فيما بعد، وسواء ذلك أكان من حيث حالة الترقب التي تسبق الإعلان عن الجائزة لمعرفة العباقرة والمبدعين المرشحين لها أو أولئك الذين سينالونها وطبيعة الأعمال التي خولتهم الحصول عليها، أم من حيث الغموض والتشكيك الذي يعتريها بعد إعلانها بشأن أسباب المنح غير الحيادية والمسيَّسة في كثير من الأحيان وفق رأي شريحة واسعة من المفكريين وأصحاب الرأي في العالم.
وبدأت القصة عندما أراد الصناعي السويدي (الفريد نوبل) ان يكفَّر عن الشعور السيء الذي حمله في ضميره نتيجة اختراعه للديناميت واتجاره به، والذي بدل أن يستخدم في خدمة الإنسانية ازهق ارواح الملايين من بني البشر، فرصد في وصيته عام 1895م جائزة أوقف لها ثروته لأجل تحفيز ومكافأة أصحاب الفكر الانساني للعمل فيما هو خير للانسان ورقي للإنسانية، لكنه بجائزته هذه صار في نظر البعض أكثر شراً منه يوم اخترع الديناميت، لما تراه هذه الشريحة من خطر هذه الجائزة وتأثيرها على الفكر العالمي المسيَّس.
منذ إطلاق النسخة الأولى للجائزة، وكثير شك واتهام يعتري هذه الجائزة وأسباب ومعايير منحها وبخاصة في مجال الآداب ولاحقاً في مجالي الاقتصاد والسلام الذين تم إضافتهما للجائزة بعد وفاة نوبل نفسه، وفى هذا السياق، وصف الكاتب الأمريكي (إيرفينغ ووليس) جائزة نوبل بأنها “فضيحة عالمية تتحكم بها الرشوة والجنس والجاسوسية السياسية والمصالح الاقتصادية وفساد الضمير”، وعبر الأديب اليوناني (كزنتزاكيس) في معرض حديثه عن الجائزة وربطها بأسباب إطلاقها بقوله: “لم أفهم كيف يتاجر رجل في الديناميت ثم يدعو للسلام وينشئ جائزة عالمية لمَن يسهمون أو يساهمون في خدمته؟“.
ونرى كذلك أن الأديب العالمي (ليو تولستوي) عملاق الأدب الروسي صاحب “الحرب والسلم وأنا كارنينا” قد حرم من هذه الجائزة رغم قامته الأدبية السامقة التي تجعله أعظم الروائيين على الإطلاق في نظر الكثيرين، ومثله مواطنه الأديب (أنطون تشيخوف) الذي يعد أفضل كاتب قصص قصيرة عبر التاريخ، فقط نظراً للعداء التاريخي بين السويد وروسيا، حيث عبر تولستوي عن موقفه الرافض لهذه الجائزة من خلال رأيه “أن النقد الأدبي المجامل مثله مثل الجوائز والمكافآت الكبيرة تؤدي إلى فساد الخلق الفني والأدبي للمبدع وابتذاله”.
واستناداً إلى الشكوك والانحياز السياسي الصريح في كثير أحيان لهذه الجائزة، فقد أقدم الكثير من المبدعين العالميين على رفضها، وذلك كموقف مبدئي تجاه تلك الشكوك التي تعتري معايير المنح لهذه الجائزة، وكذلك تجاه الأهداف السياسية التي يرونها تتخفى وراء دوافع المنح غير الحيادي لبعض الفائزين بها، والذي يجعل من هذه الجائزة رشىً عالمية تمنح لتمرير مواقف سياسية وفكرية خاصة بفئة من البشر، وهو ما لا يقبله أي صاحب فكر حر مبدع.
فبالإضافة إلى العملاق (برنارد شو) الذي صدَّرنا الحديث بمقولته في هذه الجائزة، رفض الشاعر الروسي (بوريس باسترناك) مؤلف رواية “الدكتور زيفاجو” جائزة نوبل عام 1958م، والذي منح الجائزة رغم استحقاقه لها برأي البعض فقط بناءً على مواقفه المعادية للشيوعية في الاتحاد السوفيتي الذي منع طبع روايته ولاحقه، وقد رفض هذه الجائزة لأنه رأى “أن نوبل مجرم في حق البشرية باختراعه للديناميت”، ومثله فعل الأب الروحي للوجودية الفيلسوف والأديب الفرنسي (جان بول سارتر) حيث منح جائزة نوبل عام 1964م فرفضها وتمرد على فكرتها، معللاً ذلك بقوله “إن حكم الآخرين علينا ما هو إلا محاولة تحويلنا إلى موضوع وتشييئنا، بدلاً من النظر إلينا كذوات إنسانية”.
ولكن ورغم قبوله الجائزة إلا ان “غابرييل غارسيا ماركيز” الأديب اللاتيني العظيم صاحب رائعة “مئة عام من العزلة” والذي مُنح جائزة نوبل عام 1982م قال: “سامحوني إذا قلت إنني أخجل من ارتباط اسمي بجائزة نوبل، وإنه لمن عجائب الدنيا حقاً أن ينال شخص مثل بيغن جائزة نوبل في السلام تكريماً لسياسته الإجرامية التي تطورت في الواقع كثيراً خلال السنوات الماضية”.
إن الحيادية المزيفة أو لنقل الضبابية التي قد تبدو لنا من خلال منح جائزة نوبل للآداب لكتاب مناهضي الشيوعية والوجوديين أمثال (بيرتراند راسل عام 1950م، البير كامو عام 1957م، باسترناك عام 1958م، الكسندر سولزنتسين عام 1970م) ومنحها كذلك ليساريين امثال (الكاتب الامريكي ارنست همنغواي 1954م، الروائي السوفييتي ميخائيل شولوخوف عام 1965م، الشاعر الأمريكي اللاتيني من تشيلي بابلو نيرودا عام 1971م)، ثم ختامها هذا العام 2012م بمنحها للروائي الصيني الشيوعي (مو يان)، ما هو إلا انعكاس عميق لحركة السيطرة والنفوذ في السياسة العالمية وبخاصة الأورو-امريكية المتغيرة تحت وطأة النفوذ والقوة الاقتصادية والعسكرية للشيوعية السوفيتية سابقاً والصينية حالياً، وتبدل ظروف ومعطيات اللعبة السياسية، والتي تتلاعب في هذه الجائزة والقائمين عليها من جهة، وإلى المسار الثقافي المسيَّس من جهة أخرى، والذي من أهم صفاته إن أريد له تحقيق أهدافه الحفاظ على الحد الأدنى (الذي عليه علامة استفهام؟) للمستوى الإبداعي لدى الفائزين بهذه الجائزة للحفاظ على نوع من المصداقية والمهنية ولو الوهمية حتى يكون لها الأثر الثقافي اللازم للتوجيه الاستراتيجي المطلوب للسياسة، ولمثل هذه الاسباب ايضاً كانت تحجب هذه الجائزة في بعض السنوات.
ولعلنا نجد في منح نوبل للآداب عام 2006م للكاتب التركي (أورهان بوموق) الذي أثارت الاتراك تصريحاته المستفزة بشأن المجازر التي ارتكبت بحق الأرمن والأكراد، ما يتفق تماماً مع التوجه الغربي والصهيوني للتركيز على شؤون الأقليات في إطار سياسة العولمة ومشروع التفكيك وإعادة تشكيل الخارطة السياسية العالمية من خلال الشكل المنمق الجديد لسياسة “فرق تسد” الاستعمارية المتمثل بنظرية “صدام الحضارات”، وهو ما أكده منح الجائزة ايضاً عام 2009م للكاتبة الألمانية من أصل روماني (هيرتا ميولر) وهي كاتبة غير معروفة إلا لقلة قليلة حتى ضمن ألمانيا، لكنها تنتمي للأقلية الألمانية في رومانيا، وتدافع عن حقوق الأقلية الألمانية في رومانيا، وهي ليست مبدعة معروفة ولا صاحبة مدرسة أدبية أو شعرية جديدة، لذا لا بد من البحث لا في الأدب بل في السياسة عن سبب اختيارها.
كما يلاحظ ارتفاع نسب اليهود بقوة بين الحائزين على جائزة نوبل بكافة فروعها، ومنهم على سبيل المثال فقط الكاتب المجري (أمري كيرتيز) الذي نال “نوبل للآداب” عام 2002م لكتاباته فقط عن المحرقة اليهودية، أما المسلمون الذين يرشحون للجائزة أو ينالونها، فهم قلة قليلة جداً، وحيث تجد أسماؤهم، تلاحظ أنهم عامة في حالة صدام مع مجتمعاتهم في مفاصل رئيسية، مثل قضية التطبيع مع اسرائيل التي أيدها (نجيب محفوظ) الفائز بنوبل للآداب عام 1988م، وكذلك مثل الكاتب الهندي (سلمان رشدي) واضع كتاب “الآيات الشيطانية” الذي هاجم فيه الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وقد رشح للجائزة ولم ينلها.
كما أن منح الروائي الصيني (مو يان) جائزه نوبل للآداب مؤخراً في اكتوبر هذا العام 2012م ، أثار عاصفة من الانتقادات كان أقواها من مفكري وكتاب دعاة الديمقراطية الصينين، حيث أخذ عليه علاقته بالحزب الشيوعي الذي يظن بأنه عضو فيه، واقتباسه وإشادته بالخطاب الشهير للزعيم (ماو تسي تونغ) الذي ألقاه عام 1942م حول الأدب والفن وكان أساساً لعمليات تطهير وإعدام، وحملة من الحزب الشيوعي وضعت فنانين وكتاباً تحت الوصاية الأمر الذي تناقضه أهداف الجائزة في السلام والحرية، هذا الموقف استثمرته الصين ورحبت بحصول مواطنها (مو يان) على الجائزة وعبرت عنه بانه دليل اتساع نفوذ الصين وتفوقها، في حين، عندما منح المنشق الصيني (لياو تشياوبو) جائزة نوبل للسلام عام 2010م، والذي تلف منحه الجائزة أيضاً شكوك حول التدخل الأورو-الامريكي للضغط على الصين من خلال ملف حقوق الانسان في ظل لعبة تنازع المصالح والنفوذ بين الجانبين، حيث أنه لا يقارن مهما كان نضاله السلمي بأحد أبرز رموز وزعماء دعاة النضال السلمي واللاعنف امثال (المهاتما غاندي) الذي رشح للجائزة مراراً ولم ينلها طبعاً لمعارضته للاستعمار البريطاني حينها، لنرى الصين عندئذ تتهم الجائزة وحكامها في عام 2010م حين منحت لمواطنها الآخر (تشياويو) واصفةً اعضاء لجنتها بالمهرجين، وهو ما لا يمكن قراءته إلا قراءة سياسية بعيدة كل البعد عن الثقافة والحياد في ضوء التمدد الصيني وازدياد النفوذ الذي عبرت عنه الصين ذاتها.
ويتعزز هذا التحيز السياسي في الجائزة من خلال “نوبل للسلام” أكثر منه في “نوبل للآداب” خاصة أن “نوبل للآداب” تفيد موضوعياً في تعزيز توجهات الثقافة في مرحلة تاريخية معينة لخدمة أهداف استراتيجية سياسية محددة، في حين أن “نوبل للسلام” هي مكافئة لمواقف سياسية تمت وانتهت غالباً، لذا تكون نتائجها أكثر جرأة إن لم نقل وقاحة.
ولعله في جدلية معايير منح هذه الجائزة “نوبل للسلام” لبعض الأسماء مؤشرات ودلائل لطبيعة التوجه السياسي لمانحيها، سواء فيما ذكرناه أنفاً أو في بعض الأسماء والشخصيات الأخرى والتي منها على سبيل الذكر لا الحصر: الأمريكي المخضرم مهندس السياسة الأمريكية المعاصرة (هنري كيسينجر) عام 1973م وما يرتبط به اسمه من جرائم سواء من خلال دعمه للصهيونية أم لما قامت بها الولايات المتحدة في فيتنام وسوها من حروب، و(أنور السادات) و(مناحيم بيغن ذي التاريخ الحافل بالمجازر والجرائم الاسرائيلية) عام 1978م على أثر توقيع معاهدة كامب ديفيد للتطبيع بين مصر واسرائيل، ومؤسس حركة “تضامن” البولندية المناهضة للسوفييت (ليخ فاليسا) عام 1983م، والكاهن الأكبر لديانة “المحرقة اليهودية” الحائز على جائزة “حارس صهيون” (أيليا فيزل) عام 1986م، والمنشق الصيني (الدايلي لاما) عام 1989م، ومقوض وهادم الاتحاد السوفييتي (ميخائيل غورباتشوف) عام 1990م، وموقعو اتفاقية أوسلو (ياسر عرفات) و(شمعون بيريز وإسحق رابين أصحاب أسوء تاريخ إجرامي في مجازر إسرائيل) عام 1994م، و(كوفي عنان) عام 2001م الذي أدى تسلمه لملفات رواندا والبوسة والهرسك الى حدوث أفظع مجازر القتل والتطهير العرقي في التاريخ الحديث راح ضحيتها مئات الألاف من البشر، وكذلك خلال نيابته وترأسه للامم المتحدة حدثت اسوء الحروب في منطقة الشرق الاوسط (حرب الخليج الثانية والثالثة وحرب افغانستان). والمعارِضة الإيرانية (شيرين عبادي) عام 2003م، ورئيس هيئة الطاقة النووية الدولية (محمد البرادعي) عام 2005م إبان تحقيقه في الملف النووي العراقي والايراني. و رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (باراك أوباما) عام 2009م بعد استلامه منصبه الرئاسي مباشرة وقبل أن ينجز شيئاً “بناء على نواياه الحسنة” بحسب ما وصل إليه أعضاء لجنة الجائزة، وليس اثر تراجعه أمام اللوبي اليهودي حول مطلبه بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية بالكامل كما يرى آخرون، وتلميعاً لصورة أمريكيا بدعمها للتحرر والعدالة إثر فظائعها في افغانستان والعراق وتدهور صورتها وبخاصة في الشرق والعالم الاسلامي. ولربما كانت (توكل كرمان) الناشطة اليمينة التي حازت على جائزة نوبل للسلام عام 2011م حالة استثنائية ظاهرياً تحتاجها الجائزة بين الفينة والفينة للايهام بحياديتها وموضوعيتها ضد الجنايات الكبيرة والعديدة التي تجنيها في هذا المجال، لكنها حقيقة في اطار التسيِّس العلني لهذه الجائزة في محاولة لاستيعاب تبعات الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة وأبعاده الاقليمية والدولية، واخيراً وليس آخراً، تكلل جائزة نوبل للسلام تخبطها بمنح الجائزة لعام 2012م إلى (مجلس الاتحاد الاوربي في بروكسل)، كإحدى سياسات الدعم لهذا الاتحاد الذي راح يتداعى تحت وطأة الانهيارات الاقتصادية المتلاحقة للدول أعضائه مهددة اياه بالتفكك والانهيار وهو الامر الذي سيكون له تداعيات وانعكاسات عالمية خطيرة اقتصادية وسياسية، الاتحاد الاوربي هذا الذي أثبت فشله وعجزه خلال عام 2012م بالذات عن مد يد العون للشعب السوري الذي يتعرض لأبشععمليات القتل والذبح العلني من قبل نظامه المستبد طيلة عام ونصف حتى اليوم، العجز حتى عن القدرة على اتخاذ اي خطوة عملية حقيقية توقف المجازر وانتهاكات حقوق الانسان التي تتم كل يوم في سوريا متعللاً بمواقف بعض الدول الكبرى كروسيا والصين، في حين أنه لما أراد التدخل وإنهاء الحرب في دول البلقان لم تمنعه وتمنع امريكا روسيا بمواقفها المساندة للصرب، الا اللهم اذا اعتبرنا بعض العقوبات الاقتصادية (كمنع تصدير المشروبات الكحولية والكافيار) ومنع السفر عن بعض المسؤولين السوريين انجازاً على صعيد الدعم الانساني للشعب الذي يقتل ويذبح على مرأى العالم المنادي بالحرية وحقوق الانسان ليل نهار.
وقد يكون من الصعوبة بمكان في مقامنا هذا الاحاطة بكل جوانب التشكيك والاتهام التي تلف قرارات منح هذه الجائزة، إلا أنه من ألطف ما قيل في هذا الصدد، ما صورته الكاتبة البريطانية (فرانسيس سوندرز) في كتابها “من الذي دفع للزمَّار؟ الحرب الباردة الثقافية“، في وصفها لهذه الظاهرة حيث أطلقت لقب الزمَّار الذي استعرناه عنواناً لحديثنا هذا على اللاعبين الأساسيين في السياسة الثقافية العالمية من خلال الجبهة الثقافية الليبرالية والرأسمالية العريضة ومعها من استقطبت (من راديكاليين سابقين ومثقفين يساريين من الذين تحطم إيمانهم بالماركسية والشيوعية بعد انهيارها، ومؤسسات وهمية وتمويل سري ضخم) والتي أنشئت وحشّدت في معركة ضارية بدعوى حرية التعبير وتبنيها كحرب باردة ثقافية من أجل الاستيلاء على عقول البشر، حيث قامت من خلال هذا التحشيد وحملة الإقناع الهائلة فى حرب دعاية تخطط لها وتديرها “منظمة الحرية الثقافية” والتى هي بمثابة وزارة غير رسمية للثقافة الأمريكية، لتكون هي أو أدواتها “الزمَّار” الذى يدفع له ثمن ما يطلبه من “ألحان”، فهل شاركت جائزة نوبل في عزف تلك الألحان لتكون هي الزمَّار بالوكالة لها او لغيرها؟
الدوحة، 17/10/2012م
- · رابط نشر المقال في موقع “الألوكة”
http://www.alukah.net/Culture/0/45759/